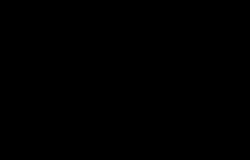اخبار العرب -كندا 24: الأحد 25 يناير 2026 12:39 مساءً في روايته «جنون مصري قديم» يضع الروائي المصري طلال فيصل المرويّة التاريخية في مختبر سردي بوصفها مادة فنية مرنة تتشكّل داخل بناء تخييلي جديد، حيث تصبح النصوص التاريخية القديمة جزءا من النسيج الحكائي المعاصر، وشريكاً في تساؤلاته وحيرته إزاء كتابة التاريخ.
في الرواية، الصادرة أخيراً عن دار «ديوان» للنشر بالقاهرة، تنطلق الحكاية من عتبة أستاذ تاريخ أكاديمي مُتقاعد، تقوده حزمة أوراق لمؤرخ مملوكي مجهول يُدعى جلال الساعي إلى مغامرة تحويل تلك الأوراق وصوت صاحبها إلى رواية، مغامرة تجعله يجلس على مقعد الروائي لأول مرة في حياته، بعد سنوات طويلة من التعامل مع التاريخ بوصفه علماً صارماً، ليكتشف داخل نفسه دافعاً وجودياً للكتابة: «غرقتُ في الكتابة وأنا لا أعرف حتى هذه اللحظة لمَ أكتبها رواية. لعلي أسلّي نفسي وقد خرجتُ على المعاش، ولعلي أجربُ حظي في شيء جديد ربما ينفعني بما لم ينفعني به التاريخ».
تعلن الرواية انحيازها الصريح لفن الحكاية، في مواجهة إقصاء المشاعر من سرد الوقائع. فالتاريخ -كما يراه الراوي- عاجز عن احتواء الخوف والذعر والانكسار الإنساني: «لسوء الحظ، يهمل المؤرخون تماماً أمر المشاعر وهم يدونون لنا أحداث ما جرى». بهذا المعنى، لا تتحوّل الرواية إلى مجرّد استعادة لسيرة «الأشرف برسباي»، أحد أبرز سلاطين دولة المماليك، بل إلى مساءلة جذرية لطبيعة المعرفة التاريخية نفسها، وحدودها الموضوعية، وكيف يُعاد إنتاج الوقائع داخل خطاب سردي يعترف بتدخّله وتأويلاته وشططه.
لعبة الاسم
لا يكتفي طلال فيصل برسم شخصية راوٍ متقاعد يحوّل أوراقاً تاريخية إلى رواية، بل يبدأ لعبته السردية منذ اللحظة الأولى حين يُطلق اسمه الحقيقي على اسم بطله الروائي نفسه، ليحمل أستاذ التاريخ المُتقاعد اسم «طلال فيصل»، في تطابق مقصود بين المؤلف وشخصيته الروائية، بما يضع القارئ مباشرةً داخل منطقة ملتبسة بين الكاتب والراوي، وبين من يكتب ومن يُكتب عنه.
لا يعمل هذا التطابق بوصفه حيلة شكلية، بل بوصفه تقنية سردية تنتمي إلى تقاليد التخييل الذاتي والميتا سرد، حيث يتحوّل فعل الكتابة نفسه إلى موضوع للحكي، ويتقمّص المؤلف شخصية داخل عمله، لا بوصفه مؤرخاً يمتلك سلطة المعرفة، بل بوصفه راوياً مرهقاً، متقاعداً، يكتب ليقتل الوقت، وليسلّي نفسه في وحدته، وفنياً فإن حضور الكاتب باسمه داخل النص لا يهدف إلى ترسيخ سلطة المؤرخ، بل إلى تفكيكها، وتحويل السرد إلى مساحة نقدية يتجاور فيها البحث والتخييل، والوثيقة والشك، في صيغة رواية تعيد التفكير في الماضي أكثر مما تكتفي باستعادته.
لا تستدعي الرواية زمن المماليك بوصفه زمناً غابراً يُروى من مسافة، بل بوصفه نموذجاً أولياً لجنون السلطة حين يتحوّل الحكم إلى «لعبة» لا تخلو من مشاهد هزلية وسوداوية معاً، مثل مشهد تنصيب سلطان «رضيع» على رأس السلطة، في إشارة إلى عالم يحكمه العبث: «يشير ططر للأمير ببغا المظفري، أكبر المماليك سناً ومقاماً، أن يجاور السلطان أثناء تنصيبه، وتظهر مشكلة بسيطة حين يحاولون وضع عمامة السلطنة على رأسه فيفاجئهم صغر رأس الصغير وهي تغطس في العمامة».
طبقات الصوت
تنهض الرواية على معمار أسلوبي مركّب يقوم على تبادل الأصوات السردية؛ هناك أولاً صوت المؤرخ التاريخي المُعايش لزمن المماليك، الذي يكتب من قلب زمنه وبمنطق الشاهد لا المعلِّق اللاحق، فتتحرّك لغته في أفق يومي مألوف ما بين الأمراء، والمؤامرات والأسواق، والبيمارستان، وأبواب القاهرة، في تسجيل وقائعي ينشغل بمنطق التدوين بلغة المخطوطات القديمة، بما في ذلك الدعاء الذي يُذيّل أوراق المؤرخين القدامى: «ولعل الله يغفر له بحسن صنيعه مع بركة».
إلى جوار هذا الصوت، يبرز صوت البطل العليم المتدخّل، الذي يُعلّق ويفكك ويؤوِّل بسخرية هادئة وهو يكتب روايته، بما لا يخلو من تحليل نفسي وتفكيك منطقي للمروية التاريخية، يضاف إلى هذين الصوتين طبقة ثالثة تعمل كجسر بينهما، وهو صوت شيوخ التدوين ومؤرخي العصر المملوكي أنفسهم، عبر توظيف مقاطع مقتبسة من كتب التاريخ للمقريزي وابن إياس وبدر الدين العيني وابن تغري بردي، وكتبهم التي تُعدّ في علم التاريخ مصادر أولية لفهم ذلك الزمن.
لا تُدرج تلك النصوص بوصفها إحالات علمية، بل بوصفها أصواتاً سردية مستقلة تضع القارئ داخل المنظومة المعرفية الخاصة لزمن المماليك، حيث تختلط السياسة بالغيبي، والسلطة بالتأويل، والوقائع بالكرامات والنبوءات.
يخلق هذا التراكب الصوتي مساحة تبادلية بين كل من خطاب المؤرخ القديم، وخطاب الراوي التاريخي المعايش، وخطاب الراوي المعاصر الناقد، بما يقدم التاريخ كنص مفتوح يعيد مساءلته بدلاً من تكريسه.
ولا يكتفي الراوي بالمعايشة أو التعليق، بل يتحكم في السرد بوصفه صانع حبكة، فهو، على سبيل المثال، حين يتحدث عن صعود «بدر العيني» في بلاط «برسباي»، لا يقدّم الوقائع دفعة واحدة، بل يصنع توتراً سردياً مقصوداً: «لم يجتمع مجلسُ مشورة واحد في زمن برسباي، إلا وكان الرجل حاضراً فيه حتى حدث ما حدث مما سنأتي على ذكره لاحقاً». وهو أسلوب سردي يتحكم في الإيقاع، ويؤجّل الحدث عمداً، ويعيد توزيعه على الزمن الحكائي، ويتحوّل «بدر العيني» من شخصية تاريخية إلى بطل في حبكة روائية له صعود ونفوذ وذروة وانكسار مؤجّل.
العدالة التاريخية
يقود السرد إلى مساءلة الذاكرة الثقافية، فلماذا بقي المقريزي حياً في الوعي العام، بينما تراجع بدر العيني؟ ومن يصنع قانون المؤرخين؟ ومن يقرّر من يبقى ومن يُنسى؟ في ظل سؤال مفتوح حول ما إذا كان التاريخ علماً مُحايداً أم فناً سردياً محكوماً بالاختيار والرؤية. أما جلال الساعي، كاتب الأوراق المجهول، فيحمل رمزاً فنياً لمن سقطوا من الذاكرة الرسمية، فقد عاش الطاعون، ورصد الجنون، وشهد شطط السلطة، ثم اختفى اسمه من كتب التاريخ الكبرى، وكأن الرواية كلها محاولة إنقاذ أثر إنسان محذوف من السجلات.
غير أن «الجنون» يظل الثيمة المركزية التي تنتظم حول الرواية كلها، ليس بوصفه توصيفاً نفسياً فردياً، بل معياراً سياسياً وأخلاقياً، من «المؤيد شيخ» إلى «برسباي»، ومن رجال البلاط إلى المحتالين و«البهلوان»، فتدور السلطة في فلك فقدان الرشد، ويتحوّل الجنون إلى مبدأ بنيوي لفهم السياسة، بما توحي به عبارة على لسان الشخصية الروائية التي تتقمص «المقريزي»، وتلخّص رؤيتها السوداء للسلطة: «أظنهم جميعاً مجانين يا خالي، غير أن جنون هذا باهظ التكاليف».
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير